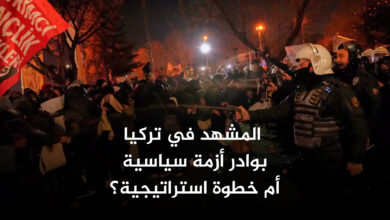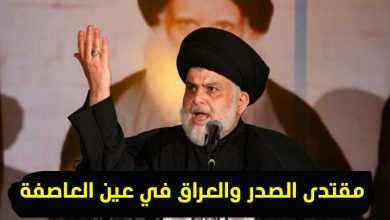ذكرى مرور 102 عامٍ على مؤتمر لوزان
د. مرشد اليوسف

في صيف 1923، حين كانت الدول الكبرى ترسم خرائط الشرق الأوسط على طاولات التفاوض، خرجت إلى العلن اتفاقية اسمها لوزان، أنهت الإمبراطورية العثمانية رسميًا، وأنشأت الجمهورية التركية الحديثة، وأعادت رسم حدود بلداننا كما نعرفها اليوم. ولكن خلف هذه الخرائط المرسومة بالمداد الأسود، كانت هناك شعوب كاملة تُمحى من المعادلة، وفي مقدّمتها الكرد.
الذكرى الأليمة:
مرّت 102 عاماً على توقيع اتفاقية لوزان (1923). ولا تزال تداعياتها تُلقي بظلالها على كل صراع في المنطقة، من جبال قنديل إلى شوارع قامشلو، ومن دياربكر إلى سنجار، ومن أنقرة إلى جنيف.
غير أنّ العالم الذي سُوّي تحت طاولة لوزان لم يعد كما هو، والأرض التي قسّمت على مقاسات الدول القومية بدأت تتصدّع.
والسؤال اليوم ليس فقط عن مصير اتفاقية لوزان، بل عن مصير العالم الذي هندسته هذه الاتفاقية، وهل ما زال قابلًا للاستمرار في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الشرق الأوسط.
والحقيقة أن لوزان أكثر من اتفاق… إنّها عقيدة.
ومن يقرأ بنود لوزان يظن أنّه أمام معاهدة حدود، لكنّها في جوهرها كانت إعادة تشكيل للهوية السياسية والعرقية للمنطقة؛ لقد أقامت حدودًا، ولكنّها أيضًا أنكرت شعوبًا، وحوّلت الكرد، الذين كانوا حاضرين في مشروع الدولة العثمانية بصفتهم شريكًا تاريخيًا، إلى أقلية بلا صوت، بلا لغة، بلا اسم.
وهكذا وُلدت الجمهورية التركية الجديدة من رحم الإنكار الشامل؛ ولم يكن هذا الإنكار تركيًا فقط، حيث أنّ لوزان سحبت اعتراف القوى الكبرى بأي كيان كردي، سواء في تركيا، أو في العراق، أو في سوريا، أو في إيران.
كانت رسالتها واضحة:
الكرد ليسوا شعبًا سياسيًا.
لكن الشعوب لا تُمحى بالقرارات، فمنذ اليوم التالي للاتفاقية، بدأت مقاومة الكرد لتاريخ الإنكار، واشتعلت الثورات المسلحة، وقامت الانتفاضات، وبدأ النضال السياسي، وأُعلِنت حرب الوجود.
ومن خنادق ديرسم إلى جبال زاغروس، ومن سجون آمد إلى مدن الجزيرة السورية، قاوم الكرد لعقود ليكتبوا سطرًا جديدًا في تاريخهم الذي حاولت لوزان طمسه.
وفي السنوات الأخيرة، انتقلت المقاومة من موقع الدفاع إلى موقع البناء.
ففي العراق، وُلد إقليم كردستان ككيان دستوري. وفي تركيا، باتت القضية الكردية محور الصراع الداخلي.
وفي سوريا، وُلدت تجربة “روجافا” كأول مشروع سياسي ديمقراطي كردي تعدّدي في التاريخ الحديث للمنطقة.
وربما لا توجد ضربة أعمق للوزان من تلك التي وجهتها روجافا؛ فبينما اعتمدت لوزان على إنكار التعدد، قدّمت روجافا نموذج الأمة الديمقراطية، الذي لا يكتفي بالاعتراف بالشعوب، بل يعيد صياغة العلاقة بين الشعوب على أساس التشاركية، وروجافا لم تكن منطقة خارج سيطرة النظام السوري فحسب؛ بل هي إعادة تعريف للسيادة، للحدود، وللهوية. وهي بهذا المعنى، مشروع سياسي واجتماعي بديل للمنظومة التي رسّختها لوزان.
ولهذا فإنّ كل مَن يحاول إسقاط روجافا لا يحارب تجربة إدارية فحسب، بل يحاول إعادة تثبيت أسس لوزان؛ دولة قومية واحدة، لغة واحدة، هوية واحدة.
وفي الجانب الآخر من الحدود، تركيا تعيش مفارقة غريبة؛ فحكومة العدالة والتنمية التي صعدت لتفكيك الكمالية، تبنّت في البداية خطاب السلام مع الكرد، ثم سرعان ما عادت إلى مربع القومية.
واليوم، ومع تعثر الدولة التركية في حربها الداخلية والخارجية، يعود خيار السلام مع الكرد كضرورة لا كخيار.
لكن السلام الحقيقي – إن حدث – لن يكون مجرّد مصافحة؛ بل سيكون، بمعنى ما، نهاية سياسية للوزان؛ لأنّ جوهر الاتفاقية كان نفي الكرد، فإذا تم الاعتراف بهم كشركاء، سقطت الأسس التي قامت عليها الدولة التركية الحديثة.
والشرق الأوسط بعد لوزان ليس الشرق الأوسط قبل لوزان؛ فالشعوب تتوحّد الآن وتنتزع حقّها في صياغة مستقبلها، ومشروع الشرق الأوسط الجديد لن يُبنى من فوق، بل من القرى والمجتمعات والقيم التشاركية.
والكرد، الذين كان يُنظر إليهم كأقليات متناثرة، باتوا قوة سياسية موحّدة، قادرة على الفعل والمبادرة وصياغة البدائل؛ لذا فإنّ مستقبل لوزان محكوم بمستقبل القضية الكردية.
صحيح أنّ لوزان لم تمت بعد، لكنّها شاخت؛ والأنظمة التي بنتها لم تعد قادرة على احتواء تنوّع شعوب المنطقة ولا على معالجة أزماتها.
وما روجافا، وما السلام الكردي – التركي القادم، وما التحوّلات الكردستانية، إلّا بشائر النهاية لعصر الاتفاقيات الفوقية، وبداية عصر الشعوب.
قد لا تُلغى لوزان بمرسوم، ولكنّها تُدفن مع كل يوم في المقاومة، في البناء، في التجارب الديمقراطية، وفي أصوات الشعوب التي تقول: “نحن هنا، ونستحق أن نُحكم بأنفسنا، لا أن نُحكم باتفاقات الآخرين.”