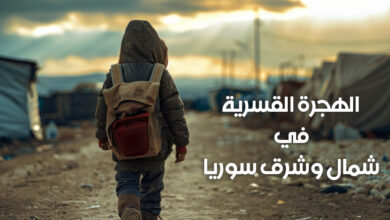تأسيس دولة المواطنة والإدارات الذاتية في سوريا
سيهانوك ديبو

لمحة عامة عن تاريخ سوريا:
انتهت الحرب العالمية الأولى رسمياً في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918م، لتُنهي الحكم العثماني في عموم المنطقة كما سوريا، ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستعمار، عهدت فيها بريطانيا للّواء علي رضا باشا الركابي، من قادة الجيش التركي حتى العام 1914م، ومن أبناء دمشق، أن يكون حاكماً عسكرياً للمدن الداخلية (دمشق وحلب)، فكان الركابي بذلك أول رئيس للوزراء وبقيت وزارته في الحكم حتى أول آذار مارس 1920م، ليتم تسليمها إلى الأمير فيصل بن الحسين، بين أيلول 1918م وحتى تموز 1920م؛ حيث أعلن الأمير نفسه ملكاً على سوريا، وأسّس المملكة السورية من خلال المؤتمر السوري العام الذي وضع دستوراً فيدرالياً للمملكة. لكن وبموجب الاتفاقيات التي وقّعها الحلفاء تم إلغاء المملكة السورية التي لم تحظَ بنيل الاعتراف، وتم وضع مخطّطات وخرائط جديدة تتقاسمها فرنسا وبريطانيا؛ فوُضِعت سوريا تحت حكم الانتداب الفرنسي الذي قرّر وقتها تشكيل عدّة دول تحت دواعي الخصوصيات القومية والدينية والمناطقية: دولة لبنان، ودولة الدروز، ودولة العلويين، ودولة دمشق، ودولة حلب، ومنطقة اسكندرون ذات الحكم الذاتي، علماً أنّ تعداد سكان سوريا آنذاك كان بحدود 1.200.000 نسمة، وكان ذلك في نهاية 1920م.
ولضمّ حوض الفرات والجزيرة/ شرقي الفرات – كمنطقة خارج الخريطة الجديدة وقتها – إلى منطقة الانتداب المتّفق عليها مع البريطانيين، شكّل الجنرال غورو قوة من الكرد (الاتفاقية موقّعة في 31 من شهر كانون الأوّل عام 1920م) ممّن تبقّى من الألوية الحميدية التي كانت تحت إمرة الملّيين وفخذ من عشيرة العنزة (بزعامة شيخها مجحم) وسرّية من السريان، واستطاعت هذه القوة المشتركة ضمّ حوض الفرات إلى منطقة الانتداب التابعة لدولة حلب. وفي الوقت نفسه دخلت فرنسا في مفاوضات مع تركيا، وتنازلت لها عن بعض المناطق (كليس وعنتاب وأورفا) لقاء التوصّل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار في 11 أذار عام 1921م. توصّل الطرفان إلى اتفاقية رسم الحدود في 20 اكتوبر 1921م، وهذه كانت الاتفاقية الأولى للحدود بين سوريا “الفرنسية” وتركيا. بعد مغادرة غورو واستلام مكسيم فيغان المفوضية السامية، تم في عام 1922م تشكيل فيدرالية الدول السورية من دول: حلب ودمشق وجبال العلويّين، بخلاف كبير بخصوص تحديد العاصمة الاتحادية، وأخيراً تم الاتفاق على أن تكون بالتناوب بين حلب ودمشق. في 5 ديسمبر 1924م تم إلغاء الاتحاد السوري وإنشاء (الدولة السورية) من دولتَي حلب ودمشق، اعتباراً من اليوم الأول من عام 1925م؛ وبذلك تحوّلت عائدية إقليم دولة حلب سابقاً إلى الدولة السورية، بينما بقيت دولة العلويين ودولة الدروز وسنجق إسكندرون خارج إقليم هذه الدولة.
كان الكرد يطالبون منذ 1924م بإنشاء دولة كردية على غرار ما تشكّل في المناطق السورية الأخرى؛ إلّا أنّ تركيا كانت تضغط على الفرنسيين لمنعهم من إعطاء أيّة حقوق قومية للكرد، مثيرة مشاكل بغية التعديل المستمرّ للحدود، ويُذكر هنا أنّ تركيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار رغم توقيعها اتفاقية الصداقة وحسن الجوار في 22 حزيران 1926م. كما يُذكر أنّ منطقة منقار البطة، كما كانت تطلق عليها في الوثائق الفرنسية (كامل شرقي الفرات حتى ديريك)، كانت تديرها المكوّنات (الكردية والسريانية والعربية) حتى اتفاقية الحدود الموقّعة في 1929م.
استمرّت عمليات تحديد الحدود السورية – التركية حتى 1933م، وفي عام 1937 تم التحالف بين الكرد والسريان، وبعض الزعامات العربية، وتمّت المطالبة بحكم ذاتيٍّ ومن ثم بدولة، أسوة ببقية الدول التي شكلت سوريا، وهي: دولة حلب، ودولة دمشق، ودولة العلويين، ودولة جبل الدروز، وإقليم/ سنجق لواء اسكندرون، ومنطقة شرقي الفرات وأقسام من غربها؛ وعندما مانعت السلطات المركزية، قابل ذلك عصيان أدّى إلى إخماده عن طريق استخدام الطيران الحربي الفرنسي على عامودا عام 1937م.
توالت الاحداث المناهضة للانتداب الفرنسي، وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت سوريا ضمن منطقة نفوذ الحلفاء؛ وفي 1943م تم تنظيم انتخابات أسفرت عن تولّي شكري القوتلي رئيساً للبلاد، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية اندلعت انتفاضة الاستقلال التي أفضت إلى نيل سوريا استقلالها الكامل في 1946م؛ هذه الانتفاضة التي تضافرت فيها جهود كافة المكونات السورية رغم تأسيسها الحديث وفق الجغرافية الحالية حتى اليوم، لتدخل سوريا من بعدها في سلسلة من الانقلابات بدأت من 1949م إلى 1970م.
دساتير سوريا:
*في 19 يونيو 1919م عقد المؤتمر السوري العام أوّل جلسة له، وانتخب محمد فوزي باشا العظم رئيساً له، وبعد اعتكافه أصبح هاشم الأتاسي رئيساً للمؤتمر، وفي 8 مارس 1920م أعلن المؤتمر دون التنسيق مع الحلفاء “استقلال سوريا” وقيام المملكة السورية العربية، وعُيّن فيصل الأول مَلكاً عليها، غير أنّ هذا الكيان لم يحظَ بأي اعتراف دولي، ورغم ذلك؛ شكل المؤتمر لجنة خاصة برئاسة هاشم الأتاسي مهمتها صياغة دستور المملكة، وجاء الدستور باثني عشر فصلاً و147 مادة، ومن أهم ما جاء فيه أنّ سوريا “ملكية مدنية نيابيّة، عاصمتها دمشق، ودين ملكها الإسلام”. كما نصّ الدستور أيضاً على أنّ البلاد تُدار على القاعدة اللامركزيّة، وأنّ لكلّ مقاطعة مجلسها النيابي وحكومتها الخاصة وحاكمها المعيّن من قبل الملك، ولا يتدخّل أحد في إداراتها وشؤونها الداخليّة، إلّا في الأمور العامة التي هي من اختصاص الحكومة المركزية.
* أُعلِن في 28 يوليو 1922م “القانون الأساسي للاتحاد السوري” بمثابة الدستور الاتحادي لمقاطعات/ دول: دمشق وحلب والعلويين، كما نصّ القانون على استحداث “المجلس الاتحادي” ليكون السلطة التشريعية العُليا في البلاد، وهو مكوّن، وفق القانون، من 15 عضواً، خمس عن كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث، وله صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ولمدة عام واحد، ولا يجوز لرئيس الاتحاد اتخاذ أي قرار دون مصادقة المجلس، وإليه تُرفع اقتراحات الحكومات المحلّية الفيدرالية الثلاث ليتم تدقيقها وإقرارها، كما أنّ للمجلس الاتحادي الحقّ في وضع بعض القوانين كالعقوبات والأحوال الشخصيّة واعتماد الموازنة العامة للدولة.
* في 14 فبراير 1928م كُلِّفَ الشيخ تاج الدين الحسني برئاسة الدولة داعياً لانتخابات جمعية تأسيسيّة جرت لاحقاً في أبريل 1928م، وعقدت الجمعية التأسيسيّة أول اجتماع لها في 9 مايو 1928م في دار الحكومة، وانتخبت هاشم الأتاسي رئيساً لها بالإجماع، وفوزي الغزّي وفتح الله آسيون نائبَين للرئيس، خاضت الانتخابات قائمتان أساسيتان هما: قائمة الوطنيين الأحرار، وقائمة المعتدلين الموالين للانتداب، وتكوّنت من 68 عضواً منتخَباً يمثّلون دولتَي دمشق وحلب دون دولتَي الدروز والعلويين، وانتخَبت الجمعية لجنة وضع الدستور في 9 يونيو برئاسة إبراهيم هنانو، وعقدت اللجنة خمسة عشر جلسة أتمّ خلالها وضع الدستور في 11 أغسطس حين تمّ التصويت عليه وإقراره في الجمعيّة؛ أكّد ذلك الدستور الفصل بين السلطات، واعتبر أنّ سوريا “جمهورية نيابية، عاصمتها دمشق، ودين رئيسها الإسلام”، وأنّ “البلاد السوريّة المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سياسيّة لا تتجزّأ”.
* في عام 1939 استقال الأتاسي وعطّل العمل بالدستور نتيجة الحرب العالمية الثانية حتى 1941م حين أعيد العمل بالدستور إلّا أنّه لم تُجرَ انتخابات، وعُيّن تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية، وقد جرت الانتخابات عام 1943م وأفضت إلى فوز الكتلة الوطنية، ووصول شكري القوتلي إلى الرئاسة، وفي عام 1947م عدّل الدستور، وعدل مرّة ثانية عام 1948م للسماح بانتخاب القوتلي لولاية ثانية مباشرة بعد ولايته الأولى، وفي 30 مارس 1949م انقلب حسني الزعيم على شكري القوتلي وعلّق العمل بالدستور، وسرعان ما انقلب عليه سامي الحنّاوي في أغسطس 1949م ونُظّمت انتخابات جمعية تأسيسيّة لوضع دستور جديد للبلاد.
* دستور 1950م:
تم تشكيل لجنة صياغة الدستور المعروف بـ”دستور 1950″ في 28 ديسمبر 1949م، وأنهت عملها في 15 أبريل 1950م، وأقرّت رسمياً في 5 سبتمبر من العام نفسه، وبدأت الجمعية مناقشة المسودة في الدورة الصيفية في 22 يوليو؛ كانت المسودة تتألّف من 177 مادة، خلال المناقشات طُوِيت 11 مادة (لم تتسنَّ لنا حتى اللحظة معرفتها علماً أنّ هناك تأكيدات بأنّها متعلّقة باللامركزية والحكومات المحلّية) وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلّفاً من 166 مادة؛ ناصّاً على أنّ دين رئيس الدولة هو الإسلام، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، أي أنّها أخلت، من خلال ذلك ومن خلال مقاربات أخرى، بمبدأ المواطنة وسعت لتكريس مركزية ثقافوية ولغوية؛ وعلى الرغم من أنّه جاء محافظاً، بشكل ظاهري، على طبيعة الحكم البرلمانية، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وسحب حق نقض القوانين والمراسيم منه بإمهاله عشرة أيام فقط للتوقيع عليها، غير أنّه حافظ على اختصاصه بالتصديق على المعاهدات الدولية، وتعيين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وقبول البعثات الأجنبية، ومنح العفو الخاص، وتمثيل الدولة، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وتوجيه الخطابات للسوريين.
كما أنّ الدستور زاد حينها من صلاحيات البرلمان؛ من خلال تمكينه من منع التنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة، ولو مؤقّتاً، كما أوجب على الحكومة الاستقالة في بداية كل فصل تشريعي، كما عزّز من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا. أمّا مواد الحقوق العامة في دستور 1950م فقد تم توسيعها وصونها، حتى بلغت 28 مادة تختصّ وحدها بالحقوق والحريات.
تم تعطيل الدستور في عهد أديب الشيشكلي أولاً، والمرة الثانية في ما بين 1958م و1961م خلال الفترة التي كانت فيها سوريا جزءاً من (الجمهورية العربية المتحدة)؛ إذ استُبدِل بدستور مؤقّت وضعه رئيس الجمهورية المتحدة جمال عبد الناصر، وبعد الانفصال عن الجمهورية أُعيد العمل بالدستور المذكور بعد إجراء تعديلات لافتة للنظر، طالت تغيير الاسم الرسمي للجمهورية من الجمهورية السورية إلى الجمهورية العربية السورية، بعد إخضاعه لاستفتاء شكلي واعتماده حتى 1963م، حين انقلب حزب البعث على النظام الدستوري القائم.
* كانت أولى قرارات (مجلس قيادة الثورة)، برئاسة لؤي الأتاسي، تعطيل العمل بالدستور واعتقال رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الوزراء خالد العظم، وفرض حالة الطوارئ التي استمرت 48 عاماً ليتم (رفعها رسمياً) في أبريل 2011م. أصدر المجلس عام 1964م دستوراً مؤقّتاً للبلاد، ثم عاد وأصدر دستوراً آخر في 1 مايو 1969م، وأمّا آخر دستور مؤقّت فأصدره بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة في 9 ديسمبر 1971م، واستمرّ معمولاً به حتى 1973م. فيما بعد تتشكّل لجنة برئاسة محمد فاضل لصياغة “دستور دائم للبلاد” أقرّ (باستفتاء) يوم 12 مارس وأصدره رئيس الجمهورية في 13 مارس بمرسوم جمهوري، وفرض من خلاله فكر حزب البعث على الدولة، وصدرت عدة قوانين في عهد سلطة البعث أنهت الحياة السياسية؛ ومنها:
قانون الطوارئ لعام 1963م الذي يحظر التظاهر ويتيح الاعتقال والتنصّت رغم أنّها كانت مقرّة في دستور 1950م ضمن الحقوق الدستورية.
قانون حماية الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965م.
قانون المحاكمات العسكرية رقم 109 لعام 1968م، الذي شرّع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية.
قانون إحداث محاكم أمن الدولة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968م.
قانون إعدام كلّ منتسِب أو ينتسِب للإخوان المسلمين رقم 49 لعام 1980م وذلك على خلفية أحداث الثمانينات.
*دستور 2012م:
في 15 أكتوبر 2011م أصدر بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 1973م ذاته، ومكوّنة من 29 عضواً، مقتصراً على ممثّلين عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية ومستقلّين وخبراء حقوقيين، وحدّد عمل اللجنة بأربعة أشهر.
في 15 فبراير 2012م سلّمت اللجنة المسودة إلى بشار الأسد، الذي أصدر مرسوماً بدعوة الهيئات الناخبة للاستفتاء عليها في 26 فبراير؛ وبحسب وزارة الداخلية السوريّة فإنّ 57% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء، وأنّ 89.4% أيدّوه، وفي اليوم التالي، أي 27 فبراير، صدر المرسوم 94 القاضي باعتماد الدستور الجديد الذي جاء محافظاً على أغلب بنود ومواد الدستور السابق.
*العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا:
بتاريخ 28 نيسان 2013م دعت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) لاجتماع حضره 48 أكاديمياً من مناطق روج آفا وشمال سوريا، هدف الاجتماع إلى وضع عقد اجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، تشكّلت وقتها ثلاث لجان: لجنة صياغة العقد الاجتماعي، لجنة المتابعة، ولجنة الإعلام، (وكان لي شرف العضوية في لجنة الصياغة وقتذاك وما تلتها). أنهت لجنة الصياغة من كتابة العقد الاجتماعي بتاريخ 24 تموز 2013م، بعد عقدها 31 اجتماعاً بمعدل خمس ساعات لكل اجتماع، طرأت على العقد الاجتماعي تعديلات تتعلّق بطبيعة الأحداث وتحرير المدن من الإرهاب والاستبداد، وفي 16 تموز 2021م اجتمع في قاعة سردم بمدينة الحسكة 158 شخصية أكاديمية وسياسية ونسوية وشبابية ومن الفعاليات المجتمعية لكلّ مكوّنات شمال وشرق سوريا من المقاطعات السبعة (الجزيرة، الفرات، عفرين، منبج، الطبقة، الرقة، ودير الزور)؛ تم في هذه اللجنة الموسّعة تكليف 25 عضواً بإعادة كتابة العقد الاجتماعي بشكل يتناسب مع التطوّرات الميدانية والسياسية في مناطق الإدارة الذاتية وعموم المنطقة، كما تم تكليف 5 أعضاء باتوا في ديوان العقد الاجتماعي. عقدت اللجنة المصغّرة 27 اجتماعاً على مدى 19 شهراً، وخلال يومين أنهت مسودة للعقد الاجتماعي بحلّته الجديدة بتاريخ 22 شباط 2023م، عرضت اللجنة الموسّعة وشاركت هذه المسودة، وخلال أكثر من 80 اجتماعاً، على كامل مناطق الإدارة الذاتية ومع المختصّين السوريين ومن بلدان عربية وأجنبية، واجتمعت اللجنة المصغّرة مع أعضاء المجلس العام للإدارة الذاتية بتاريخ 6و 7و 8و 9 من كانون الأول 2023م، وفي يوم 12 كانون الأول 2023م تمت المصادقة على العقد الاجتماعي المعمول به حتى اللحظة، والمؤلّف من: ديباجة و134 مادة، موزعاً على أربع أبواب وعشرة فصول.
التاريخ السياسي السوري والتحوّلات السياسية التي شهدتها سوريا:
انطلاقاً من أهمية كبرى لا تقلّ عن أهمية البحث، ومن ثم وضع التصوّرات المناسبة لتصويب الوجهة السورية من وجهة المنطقة برمّتها؛ من خلال استخلاص النتائج التي عكستها الحقيقة السورية منذ تأسيس سوريا الحديثة:
عند البحث في تاريخ الشرق الأوسط يجب معرفة أنّ خرائط القرن العشرين كانت تصميمية وجانبت حقيقة المنطقة، ورغم استناد أوروبا على ميكانيزم التحوّل حين غادرت الدولة الدينية إلى الدولة القومية؛ لكنّها فشلت تماماً فيما بحثته يوماً وأعلنته ذات انكسار عام (سلام ما بعده سلام إبّان انتهاء الحرب العالمية الأولى)، من يخرج من الحروب كلّها يخسر، لا غالب من الحروب إنّما مغلوبون فقط. الفرق في ذلك بأنّ أوروبا صدّرت من قلب النقيض الدولة الدينية فكرّرتها وطبّقتها في الدولة القومية. وهذا فقط يُحسَب لها خلاف الدولة القومية في الشرق الأوسط التي فرضت عليها. الحالة السورية اللحظة تؤكّد أنّ انهيار النظام السوري خلال فترة قصيرة – من 27 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى لحظة السقوط في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024م؛ خلال أقلّ من أسبوعين- هو تحقيق لفكرة تصميمية مُعلَنة مفادها أنّ الدولة القومية المركزية التي فرضت على الشرق الأوسط هدّمت في البداية من خلال إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006م، ويجب اعتبار انهيار نظام البعث السوري وسقوطه نهاية العام المنصرم نهاية شكل الدولة القومية المركزية المفروضة من قبل نظام الهيمنة على المنطقة. كما يمكن القول في هذا بأنّ نظام البعث وفكرته كان يؤدّي دوراً وظيفياً مدمّراً في المنطقة وممهّداً في الوقت نفسه لإنبات ظواهر ثقافوية غريبة على المنطقة برمّتها، كما ظاهرة الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرّفة حال داعش والنصرة والمرتبطة بالقاعدة. وأخيراً بأنّ دور الأحزاب الفاشية – حال البعث – ومصيرها في يد مشغّليها حين الانتقال إلى صفحة جديدة تلائم فقط استمرار نظام الهيمنة؛ وهذا هو حال سوريا في مرحلة البعث الممتدّة على أكثر من ستّ عقود. كما أنّ تاريخ سوريا المعاصِر يؤكّد ذلك ويعزّز على ضرورة أن يتجنّب أي نظام تُتاح له فرصة الحل تكرارَ الأخطاء المرتكبة، وأنّ كل محاولة من أجل الأخذ بسوريا نحو لون واحد ونمط واحد، قومياً كان أو دينياً، لن يكون مصيره الفشل وحسب؛ وإنما أخذ سوريا نحو التقسيم والتفتيت. ومن أجل ألّا يحدث التقسيم، ومن أجل ألّا تستجلب سكاكين تتقطّع سوريا من خلالها، لا بدّ من التأكيد على ثوابت البقاء وأسانيد الإبقاء السوري من خلال إعلان دستوري ومواد دستورية محصّنة يُكتَب من خلالها عقد سوريا ودستورها الديمقراطي. فكيف يجب أن يكون هذا العقد في هذه المرحلة التاريخية؟
عقد سوريا الاجتماعي في دستورها الديمقراطي:
مجموع الاستعصاءات السورية والانسداد في الوضع السوري، رغم انهيار نظام البعث وسقوطه في 8 كانون الأول 2024م، يؤكّد بأنّه يجب أن يهدف الدستور السوري إلى:
تحقيق الهوية الوطنية من خلال تحقيق التعايش السلمي والودّي مع الشعوب الأخرى، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها، وبناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمّن أولوية القوانين باعتبارها إرادة الشعب، وتوفير مستوى حياة كريمة للمواطنين في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع العادل بعيداً عن مفاهيم الدولة القوموية والعسكرية والدينية، وإلغاء كافة أشكال التمييز القائمة على أساس العِرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، والبلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثّلة بالتفاهم المتبادَل والعيش المشترك ضمن التعدّدية، وإعلاء حق المشاركة وتوسيعها، والالتزام بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، واحترام مبدأ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقَد.
مبادئ الدستور السوري الأساسية:
العقد الوطني السوري المرتكز على مبادئ بناء سوريا الجديدة يجب أن يتضمّن جملة مبادئ أساسية دستورية، ومواد محصّنة غير قابلة للتعديل والإلغاء يُؤخذ بها وتُعتمَد في دستور سوريٍّ جديد يليق بالتنوّع القومي والإثني والديني والتعدّد الثقافي السوري:
1- الشعب مصدر التشريع، ومصدر كل سلطة.
2– سوريا جمهورية متّحدة ديمقراطية، نظامها (مختلط) رئاسي- نيابي. وذات سيادة وشخصية قانونية، ولا يجوز التخلّي عن أي جزء من أراضيها، ويتأسس نظامها على أساس مقاصد وأهداف القرار الأممي 2254/2015.
3- رئيس/ة سوريا مواطن/ة سوريٌّ/ة. لا يتحدّد تولّي منصب الرئاسة على أساس انتماء قوميٍّ كان أو دينيٍّ؛ وهذا يُعَدُّ مؤشّراً أساسياً لحيادية الدولة إزاء أديان وقوميات ومعتقدات وثقافات سوريا.
4- تؤسّس الدولة السورية بالعمل بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي؛ وعليها ملاءمة كل القوانين مع هذه المواثيق والمعاهدات، ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهكها.
5- سوريا دولة متنوّعة قومياً ودينياً وطائفياً، تصون اللامركزية السياسية الديمقراطية، وهذا التعدّد يُعتبَر المعيار له في الوقت نفسه؛ وتُعتبَر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مثالاً على ذلك ونموذجاً فعّالاً على هذه اللامركزية.
6- السيادة للشعب ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب احتكارها أو ادّعائها؛ وتقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثّل بقانون انتخاب عادل وشفّاف يعتمد النسبية بالانتخاب إضافة إلى التوافقية، ويعتمد نظام الدوائر الانتخابية مع اعتماد اللامركزية وفصل السلطات.
7 – عاصمة الدولة دمشق.
8- شعب سوريا يتألّف من قوميات وثقافات، يحق أن تكون لغاتها أساسية في أماكن تواجدها.
9- القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية، ويجب إيجاد حلّ عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء جميع السياسات التمييزية ونتائجها، وتعويض المتضرّرين ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها.
10- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين، واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية.
11- تمكين المرأة سياسياً وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات، وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن.
12- الرجل والمرأة متساويان بالحقوق والواجبات، ولجميع المواطنين السوريين الحقوق والواجبات نفسها دون أي تمييز.
13- محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية بمختلف مسمّياتها، وتجفيف منابعها المالية والمادية والمعنوية.
14- تُعتبَر الثقافات الشرقية الإسلامية والمسيحية والدرزية والإيزدية تراثاً مشتركاً في الوطن السوري لكل مكوّناته؛ يؤكّد عليها في الدستور الجديد ويضمن خصوصيتها كأديان.
15- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، والعمل على تمثيلهم النوعي في النظام الديمقراطي المنشود.
16- ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمّرة التي عاشتها وتعيشها سوريا منذ العام 2011م.
17- حماية الطفولة، ووضع مشاريع خلّاقة لإنقاذ أطفال سنوات العنف من تبعات التهجير والعسكرة والأمية.
18- وجود هيئات قضائية مستقلّة نزيهة تتمتّع بالحرية غير المقيّدة في عملها، وتمنح الحصانة القضائية والدستورية لحمايتها من عوامل خارجية قد تؤثّر على عملها ووظيفتها الرقابية الدستورية.
19- الاقتصاد في الجمهورية السورية اقتصاد تشاركي ينحو إلى السوق المجتمعي ويحقّق العدالة المجتمعية، ويتأسّس هادفاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
20- الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوّث ومن استنزاف الموارد، والعمل على تحسينها وضمان استدامتها، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.
في مقترح الحدّ من سلطة الاستبداد المركزي، ومن أجل تشاركية السلطات، وتصوّرات عامة عن صلاحيات المركز والإدارات السورية الذاتية والصلاحيات المشتركة بينهما.
أولاً. صلاحيات الحكومة المركزية:
– شؤون الجنسية في سائر سوريا.
– السياسة الخارجية للحكومة السورية وتعيين السفراء والقناصل والبعثات الدبلوماسية للدولة.
– توقيع المعاهدات الدولية على ألّا تتعارض مع حقوق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
– شؤون إصدار العملة وصكّ النقود والمقاييس والأوزان وتحديد التوقيت.
– وحدة المناطق التجارية ومعاهدات الملاحة البحرية والتجارة وحرية حركة البضائع وحرية تبادل البضائع والمدفوعات مع الخارج.
– إعداد الموازنة العامة لسوريا، وإعطاء حصّة عادلة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من تلك الموازنة.
– حماية الإرث الثقافي لسوريا، وضمان حقوق التعليم باللّغات الأم للشعوب في سوريا.
– النقل البرّي والبحري والجوّي ضمن سوريا ومع الخارج.
– خدمات البريد والاتصالات ضمن الدولة.
– العلاقات القانونية للعاملين في سوريا والعاملين في هيئات الإدارة الذاتية بموجب القانون العام.
– التكريم بالأوسمة والميداليات والشارات ذات القيم الوطنية.
ثانياً. الصلاحيات المشتركة ما بين الحكومة المركزية والإدارات الذاتية السورية:
– الإجراءات لتشكيل هيئات سلطات الدولة.
– تشكيل قيادة مشتركة للجيش، والقوات المسلّحة في سوريا.
– إعلان السلم والحرب.
– إصدار القوانين، والمراسيم التشريعية.
– حرية التنقّل وشؤون جوازات السفر، وشؤون التسجيل، والهويات الشخصية، وشؤون الهجرة.
– تنظيم المعابر، ووضع النظام الجمركي للمنافذ الحدودية وينظّم ذلك بقانون.
– التشريعات المدنية والجزائية، وتنظيم المحاكم وتخصّصها.
– نشاط الجمعيات العامة، والمنظّمات غير الربحية.
– ما يتعلّق بشؤون الأجانب، ومنح الإقامات، واللاجئين، والنازحين.
– التعليم والصحّة والرياضة.
ثالثاً. الصلاحية الحصرية للإدارات الذاتية الديمقراطية:
– تقوم بوضع عقد اجتماعي يحدّد إجراءات تشكيلها؛ هيكل سلطاتها، وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ألّا يتعارض مع الدستور.
– تؤسّس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
– إصدار القوانين والمراسيم التشريعية، التي لا تعدّ من الأهلية الحصرية للمركز، وليس من الأهلية المشتركة ما بين المركز والإدارة الذاتية.
– تشكيل وحدات حماية تعدّ جزءاً من مؤسسة الجيش الوطني وفق صيغ وآليات متوافق عليها، وتأسيس قوى الأمن الداخلي التي تحافظ وتدافع عن الأمن والاستقرار فيها.
– إدارة الموارد الطبيعية الواقعة في حدودها الإدارية؛ توافقاً مع المركز والإدارات الأخرى.
– إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمستدامة لها على أساس الاكتفاء الذاتي.
– إعداد النظام الضريبي الخاص بها، والسياسة المالية والائتمان؛ بشكل لا يتعارَض مع قوانين الحكومة المركزية في ذلك.
– إعداد وتنفيذ السياسة الثقافية، وحماية التراث ذي الأهمية المحلّية.
– التكريم بالأوسمة والميداليات والشارات ذات القيم المحلّية.
موجَز مكثّف وخلاصة:
لا أقليات في سوريا، ولا أكثرية؛ فسوريا فيها أكثرية وطنية وأقلّية نمطية، وإذا ما كان هناك اصرار على سردية الأقلّية والأكثرية فإنّ سوريا التي تتألّف من 38 وشيجة قومية ودينية وإثنية وطائفية يمكن القول عنها بأنّها بلد الأقليات، هذا ما قالته مئة عام منصرمة من تاريخ سوريا الحديث.
ونظام سوريا الحديث؛ حكومتها الانتقالية، إدارتها المؤقّتة، حكومة تصريف الأعمال الحالية، حتى اللحظة لم تعطِ سوى مواقف وتصريحات إعلامية معسولة، لكنّها تثبت أيضاً محطات مرعبة لا تصلح مع واقع سوريا وحاجة وسوريا وتنوّع وتعدد المجتمع السوري. إنّ نظام البعث لم يسقط لأنّه فقد حاضنته الشعبية، بل انهار لأنّ حلفاءه قد تخلّوا عنه، هذه أمور غير حاسمة؛ فالحاسم في الأمر أنّ السقوط السريع للنظام فكرة تصميمية، وكي لّا يكرّر أحد أخطاء أنظمة الاستبداد المركزية الأقلّوية السابقة؛ يجب الاحتكام إلى دستور ديمقراطي ومواد قانونية تضمن العيش السوري المشترك، ولا يمكن لأحد أن يطويها فيما بعد وبلحظة استبداد، كما الحال في دستور سوريا عام 1950م.
أمّا سلّة الدستور السوري، الدستور السوري الجديد؛ فإنّه لن يكون على طريقة تنطلق بالأساس من تعديل طفيف على دستور سوريا في المرحلة السابقة، والذي جاء بدوره في ظروف استثنائية ولا يُعبّر عن إرادة شعب سوريا؛ وإذا لم يتمكّن السوريون من إنجاز دستورٍ يكون بالعقد الاجتماعي السوري فهذا يعني أنّنا أمام إنتاج الأزمة من جديد، وتكريس التبعيّة وتداعيات الأزمة وصولاً إلى التقسيم والتفتيت، دون أن يُفهَم من ذلك أنّه اختلاف على المسمّى بقدر ما هو إصرار على إنهاء الخلاف، وأنّه فرصة مناسبة ضمن هذه الفوضى منْ أن يتمّم العقد بنحوٍ ينحو إلى استقدام العهد السوري الجديد؛ فمن خلال الدستور التوافقي يتم التخلّص من التركة المفروضة على السوريين لمئة عام المنصرمة، التركة الكريهة: الدستور المفروض والهوية المفروضة ضمن الكيفيات المفروضة.
العقد الاجتماعي السوري يكون بمثابة فكّ الارتباط أو الانسلاخ من وشائج القوموية والدينوية؛ إنّها المسألة الأكثر الأهمية في تحقيق الانتماء وتحقيق الهوية الديمقراطية السورية، ودولة المواطنة العصرية التي تتحقّق من خلال مشاريع ديمقراطية تأمن سوريا من خلالها وتبتعد عن دروب الفناء.
المراجع:
- https://sl-المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية org/category/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
- كمال ديب- تاريخ سوريا المعاصر إلى صيف 2011. دار النهار – بيروت- 2011
- مجموعة من المؤلفين- العهد الوطني في ثلاث سنوات 1944- 1945-1946. دمشق